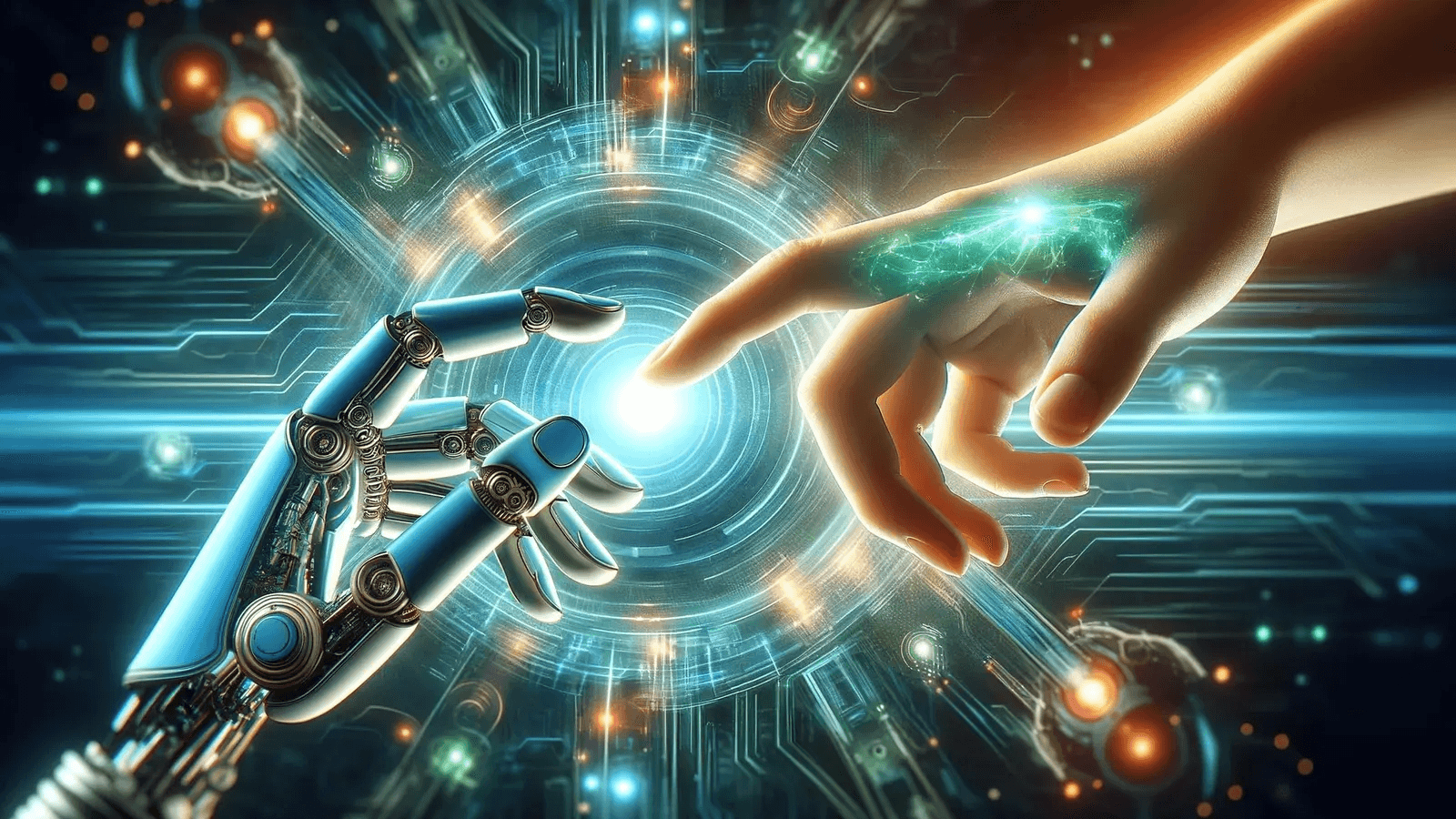أزمة الإعلام في زمن الحرب
إن التركيز الذي تابعته الجماهير العربية في تغطية الحرب على غزة، وما خلفته من أزمات، يطرح بقوة فكرتان أساسيتان، أولاهما تكريس مفهوم الرأي الواحد، وثانيهما فكرة التجهيل الممنهج بقضايا وأزمات أخرى ليست بعيدة عن اهتمام الإنسان العربي.
لقد سخرت معظم القنوات الإخبارية العربية كل إمكاناتها في السباق على تغطية الحرب على غزة، ونشرت أعدادا كبيرة من المراسلين، وخصصت الوقت كاملا لهم وللمحليين السياسيين والعسكريين، لكن المراقب لما تقدمه كل قناة من تحليلات ونقل حي يلحظ أن لكل قناة لونا خاصا مختلفا، حتى على صعيد تحليل الوقائع الميدانية، وقراءة التطورات السياسية المصاحبة، وهذا يؤشر إلى حقيقة انقياد القنوات وراء جمهور متجانس محدد التوجهات والأفكار، لا يقبل التنوع، أو وراء الحقيقة المرة، أن الخط التحريري لكل قناة يخدم أجندة الممولين أكثر مما يخدم الحقيقة.
الضحية الأولى
في كتابه "التزييف في زمن الحرب" المنشور عام 1928 يقول اللورد آرثر بونسومبي "عندما تعلن الحرب، الحقيقة هي أول ضحية"، ذلك أن الإعلام بصفة عامة يصبح جزءا من التعبئة الوطنية، وهذا ما شاهدناه على الطرف الآخر من الحرب، فالقنوات الإسرائيلية حجبت الحقائق وخضعت للرقيب العسكري، فيما خضعت القنوات العربية لدكتاتورية الجمهور، الذي لا يريد أن يرى ويسمع إلا ما يتوافق مع عقيدته وآرائه السياسية، وما يتوافق مع آماله وأحلامهن فالخروج عن هذا الخط يعرض الوسيلة الإعلامية لوصمة الانحياز لرواية العدو، واتهامات الصهينة والخيانة.
إن السير وراء رغبات الجمهور، أو قيود الرقيب، سواء الرقابة الذاتية، أو الخارجية، يجعل من الحقيقة الضحية الأولى بالفعل، ويسوق الجمهور وراء تحليلات ومضامين تتوافق مع ما يريد، حتى وإن كان بعيدا عن الحقيقة.
التجهيل بدلا من التنوير
تزامنت أحداث السابع من أكتوبر 2024 مع أزمات عديدة تشهدها المنطقة والعالم، ففي حين كانت احدى القنوات المتابعة عربيا، تنشر عددا كبيرا من المراسلين لتغطية الحرب في أوكرانيا، اختفت القصة فجأة عن شاشتها، بحجة التغطية المستمرة للحدث الغزي، وفي حين كان مضمونها كله في سياق واحد، كانت هناك أحدث كبرى تجري في السودان، وفي سوريا ولبنان، واليمن، لا يعلم المتابع عنها شيئا، وقد أدمن متابعة هذا الشأن دون سواه، ليفاجأ بدخول الساحة اللبنانية واليمنية ضمن المشهد، الأمر الذي كرس حالة التجهيل بباقي القضايا ما لم يكن لها ارتباط بهذا الشأن.
ليس أدل على ما أسلفت من المفاجأة التي هزت المشهد العربي بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دون أن يكون هناك أشارات من الإعلام قبل وقت كاف، من حيث تغطية الحراك في سوريا، بتركيز كاف للفت أنظار الجمهور لما يجري هناك، كذلك الوضع في السودان الذي كان يشهد حربا وتشريدا وقتلا لا يقل فضاعة عن الحرب في غزة، تلك الحرب التي شردت أكثر من 14 مليون سوداني، أي ما يعادل ثلث سكان البلاد، وسبعة أضعاف سكان غزة، ولم تعد السودان إلى مشهد الاهتمام إلا بعد الهدنة في غزة.
أزعم أن القنوات الإخبارية باتت بعيدة كل البعد عن خدمة الهدف من الإعلام، والدور المناط به في المجتمعات الحديثة، وأن الإعلام بات يخاطب الجمهور حسب ما يرغب، وليس حسب الواقع المعاش على الأرض، وهذا يكرس حالة توجيه الخطاب لجمهور متجانس، وعدم الاهتمام بخلق حالة من الوعي بين أطياف متنوعة، من خلال تقديم صورة واقعية للأحداث.
إن ما ينطبق على القنوات ينطبق بذات القدر على كافة المنصات والوسائل الإعلامية، من صحافة الكترونية وورقية وإذاعات.
بات واضحا لمن يراقب المشهد الإعلامي العربي عن كثب، أن القنوات التلفزيونية الإخبارية تخلت منذ زمن عن مفهوم الحياد، وهو أمر فيه كثير من الجدل حول إمكانية الوقوف على مسافة واحدة من أطراف القضية المطروحة، لكن الموضوعية وهي البديل المنطقي للحياد باتت على المحك أيضا، وتم إهمالها لصالح رغبات الجمهور، فالقنوات التي كانت تستضيف محللين إسرائيليين امتنع معظمها عن ذلك عند بدء الحرب.
العرض والطلب
قيل إن الحرب هي أدرينالين الأخبار، فهي التي تزيد من الطلب على الأخبار، وقد ساهمت التكنلوجيا في نقل الحدث بسرعة من موقع الصراع، إلى الجمهور في أماكن بعيدة عن الشظايا، ما جعل حجم الجمهور أكبر بكثير من أيام السلم، فعلى سبيل المثال شبكة الأخبار الأميركية CNN تضاعف مشاهدوها عشر مرات عندما اندلعت حرب الخليج، لذلك فإن من الطبيعي توجه وسائل الإعلام إلى تلبية طلب الجمهور، لكن إهمال باقي اهتمامات الجمهور يقلص عدد المستهلكين، فعلى سبيل المثال قد لا نتوقع من سوداني يسمع أصوات القذائف حول خيمته في مخيمات النزوج واللجوء أن ينضم إلى الجمهور المتابع لحرب تبعد عنه آلاف الأميال، بل إن مطلبه يكون معرفة ما يجري في بلاده، وحول خيمته.
الحرب في العادة تقسم المجتمع إلى ثلاثة أصناف، مشاركين ، وضحايا، ومتفرجين، ومن حق المتفرجين أن يروا مشهدا متكاملا، فالوضع الاقتصادي في أوكرانيا مثلا، قد يؤثر على حربها مع روسيا، وربما يقود إلى صفقة في سوريا، لذلك فإن تركيز المشهد في نقطة محددة يجعل الجمهور مغيبا عما سواها، حتى وإن كان له تأثير مباشر أو غير مباشر على نقطة الصراع الموضوعة تحت مجهر الوسيلة الإعلامية.
في كتاب مهد لنشوء نظرية الأجندة أو تحديد الأولويات، يقول والتر ليبمان إن "الرأي العام ما هو إلا رد فعل مباشر على ما نراه في محتوى وسائل الإعلام، أو صورة له، وهو ليس بالضرورة إنعكاسا للواقع" والكتاب نشر عام 1922 بعنوان " الرأي العام" وجاء برنارد كوهين مؤيدا له في كتابه الصحافة والسياسة الخارجية الصادر عام 1963، يقول فيه " إن وسائل الاتصال الجماهيرية لا تنجح في معظم الوقت في تحديد ما يفكر به الجمهور، ولكنها ناجحة بصفة مذهلة في تحديد ما ينبغي أن يفكر به الجمهور".
هذه المقولات التي مهدت لنظرية الأجندة، وترتيب الأولويات اعتمدت حقيقة أن المحرر في غرفة الأخبار لا يمكن أن يرى العالم كله، ولكن التطور الذي حدث منذ ذلك الحين برأيي وفر لغرف الأخبار سيلا جارفا من الأخبار، التي يضخها المراسلون، ووكالات الأنباء على شكل صور وتقارير مكتوبة وفيديوهات، تجعل من مقولة العجز عن الرؤية بحاجة إلى مراجعة جذرية من قبل باحثين أكاديميين وجامعات.
التغطية المثالية
إن التركيز على شأن أو حدث دون غيره، يفقد وسيلة الإعلام صفة الشمولية، وما شهدناه في الغطية الإخبارية للحرب على غزة في القنوات العربية ربما كان له ما يبرره في الأيام والأسابيع وربما الشهور الأولى من الحرب، باعتباره حدثا غير مسبوق، وقد أدركت عدد من القنوات هذا الأمر وعادت إلى تنويع تغطيتها الاخبارية بنشرات شاملة، فيما أصرت أخرى على متابعة الشأن الوحيد، إلى حين وقوع الحدث الجلل في سوريا في 8 ديسمبر 2024، وتأزم الوضع إلى آخر مدى في السودان، فعادت مرغمة إلى شكل من أشكال التنوع المطلوب من جمهورها.
التغطية المثلى برأيي لا تكون بالتركيز الكامل على نقطة ملتهبة بعينها، بل إعطاء هذا الملف الأولوية على غيره في أجندة القناة، وترتيب باقي الأولويات حسب أهمية الحدث للجمهور، وتداعياته وسخونته، وبعده وقربه، ومدى تأثيره.
أخيرا إن مهمة وسيلة الإعلام في الأساس، هي تزويد جمهورها بالحقائق اللازمة لتشكيل رأي أو موقف أو اتخاذ قرار، وليس فرض رأي والترويج له عاطفيا وأيديولوجيا، وزرع صورة في مخيلته بعيدة عن الواقع.